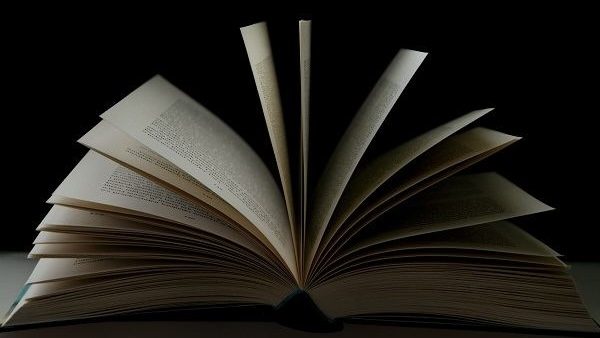جملة حقيقية أبصرتها مؤخّراً. منذ يومان حصل بيني وبين معلمتي بعض المواقف؛ جعلتني أبصر نفسي أكثر وأهذبها، ومن جملة إلى جملة أصبحت من غير أن أشعر أريد أن أنتصر لنفسي. تجاهلت حينها ذاك الشعور وأصررت على موقفي، نفسٌ تأمر بالسوء وطبعٌ علينا مجاهدة النفس للتخلص منه.
ليس المهم ما حصل حينها، المهم ما استفدته من هذا الموقف، المهم ما تعلمته وكيف صححته. فلو لم نخطئ لما تعلمنا، ولو أصررنا على الخطأ لما تهذبنا.
كثير من الأوقات ومن غير أن ندرك؛ نحاول الانتصار لنفسنا، نظن أنّ ذلك من حقنا، ونتجاهل الشعور الحي الذي بداخلنا. نتجاهل ذاك الصوت؛ صوت الفطرة والضمير الحي الذي يؤنّبنا إذا أخطأنا، وعلمت بعد اليوم وبعد التفكير بالموقف أنّي كنت أريد الانتصار لنفسي؛ وأسأل الله أن يغفر لي.
ومما جرى استفدت عدة أشياء، وابدأ بقول الله تعالى
﴿وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]
وقد جاء في تفسير السعدي لهذه الآية: أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب للانتقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.
فلو عملنا بهذه الآية لهان علينا كل شي؛ لأن الخطأ يبدأ من عدم كظم الغيظ، ولو لم يكن فضل كظم الغيظ عظيم؛ لما كانت درجة من عمل به من المحسنين، لأنّ النفس جبلت على حب الانتصار وعلى صعوبة ومشقة أن يساء إليها، والنفس الأمارة بالسوء تأتي وتزين لها أن تأخذ حقها، وأي حق هذا إذا كان يؤخذ بتكبرها على معلمتها أو ظلمها لأي أحد، وبالتأكيد لن يحصل ذلك إلا باللسان؛ لذلك من أمسك لسانه فقد غنم.
وقد جاء بالحديث: بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ ومعه أصحابُه، وقع رجلٌ بأبي بكرٍ فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانيةَ، فصمت عنه أبو بكرٍ، ثم آذاه الثالثةَ فانتصر منه أبو بكر، فقام رسولُ اللهِ حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكرٍ : أوجَدتَ عليَّ يا رسولَ اللهِ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : نزل ملَكٌ من السماء يكذِّبه بما قال لك، فلما انتصرتَ وقع الشيطانُ، فلم أكن لأجلس، إذ وقع الشيطانُ.
فالشيطان يحاول النزغ بين المؤمنين، وكثيراً ما ينجح بذلك، فالشيطان من جهة والنفس الأمارة بالسوء من جهة أخرى تحاول أخذ حقها وتظن ذلك حقها، وما هو إلا فعل من الشيطان وتلبيس عليها. وهنا أبو بكر كان من حقه الرد عليه ومع ذلك قام الرسول لأنه أتى الشيطان؛ يعني كان الرد من فعل الشيطان فكيف بمن يحاول أخذ حقه وهو المخطئ، فسبحان الذي أنار بصيرتنا.
وأريد أن أنبه لشيء وهو ألا نأخذ قراراتنا حينما نكون غاضبين؛ لأنه لن يندم عليها سوى نحن، وربما يُنسى الموقف ولكن القرار الخاطئ الذي اتخذ حينها يبقى أثره. وكثير من الناس تبدأ مشاكلها من الغضب، وبعد ذلك تندم كثيراً على أخذ قرار حين غضبها، وأحياناً يكون قراراً مصيريّاً؛ كمن قررت الطلاق وبعد أن أبصرت ندمت أشدّ الندم. لذلك وصى الرسول بعدم الغضب فقد جاء في الحديث أنَّ رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوْصِنِي، قالَ: لا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قالَ: لا تَغْضَبْ.
الغضب غريزة ركبها الله في طبيعة الإنسان والناس متفاوتون في ذلك، وهناك غضب محمود وهناك غضب مذموم؛ فمن غضب لدينه وللحق فهذا محمود، ومن كان غضبه بالباطل ومن لا يستطيع كتم غضبه فهذا مذموم.
وقد وصى النبي بعدم الغضب لما يورثه الغضب من الكبر؛ فمن تواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وإذا أردنا حلًّا بعد أن غضبنا وأسأنا وتكبرت أنفسنا واتبعنا هواها وانتصرنا لها؛ فلا يوجد سوى الأعتذار، فهو ما يلين القلب. بالتأكيد سنجد صعوبة بالأمر لأن النفس لا زالت تكابر؛ ولكن هنا يجب أن نكبحها عن التكبر ونعتذر بشكل لائق مهذب. والأعتذار يورث شيئان: أوّلهم؛ أن يلين قلبك وتتحكم بنفسك وتعينها بالأعتذار على التواضع وعدم المكابرة، والثّاني؛ كسب مودة الشخص ونجاتك إذا سامحك من سؤال ربنا لك؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
وجاء بالحديث:
إذا خلُصَ المؤمنونَ من النَّارِ ، حُبِسُوا بقنطرةٍ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ فيتقاصُّونَ مَظالِمَ في الدُّنيا ، حتَّى إذا نُقُّوا وهُذِّبُوا ، أَذِنَ لَهم بدخولِ الجنَّةِ ، فوالَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدْه ! لأَحدُهُم بمنزلِهِ أدَلُّ منهُ في الدُّنيَا
أخرجه أحمد بنحوه، والبخاري في الأدب المفرد