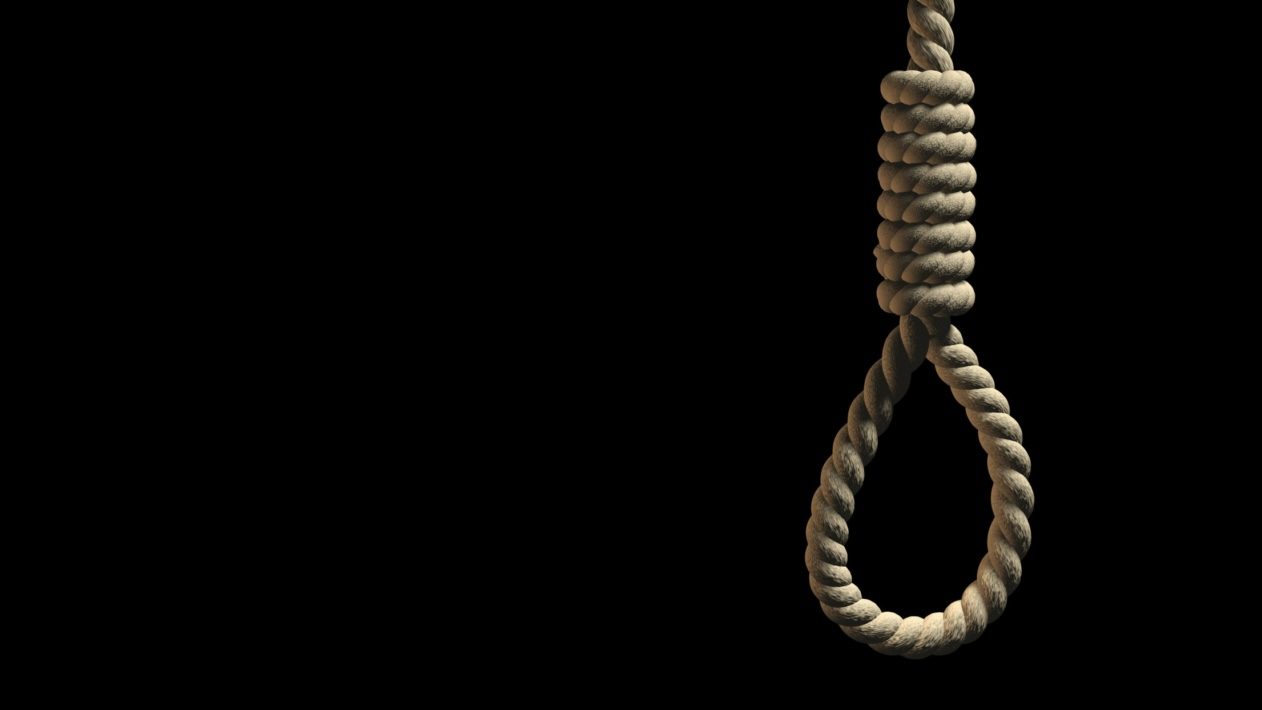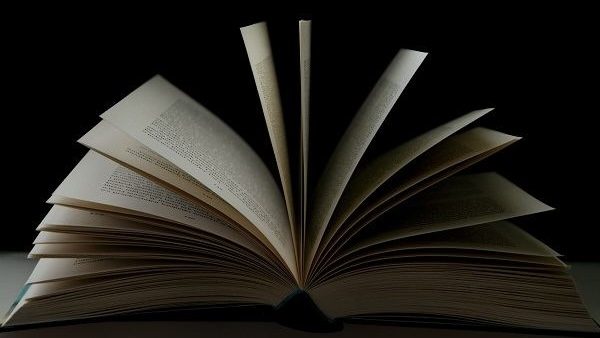هشاشة نفسية مزمنة؛ تنبئك بها حالة الانبهار والتقليد المفزعة لكل تافه وتافهة.
تراها جلية في مرض حب الشهرة والظهور؛ ولو باللعن، فيستبيح المرء أي شيء ليصنع لنفسه هالة من النجومية -في ظنه-. علامتها كثرة التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، فلعله أذنب أو استهزأ بشعيرة من شعائر الله، أو وقع في مصيبةِ سَنِّ سنة سيئة أو ذنبٍ سيئاتُه جارية إلى أن يشاء الله، لا يهم لا يهم، المهم أن منشوره انتشر وحصد آلاف التفاعلات والمشاركات.
أعراضها:
تضخيم الألم
يقصد بها مجموعة الإدراكات والعواطف السلبيّة المُبالَغ بها والتي يمارسها الفرد، وتعطي صورةً مضخّمةً عن الألم، بخلاف ما هي على أرض الواقع. وحين نطبّق ذلك على أرض الواقع فإننا نجد تفاوتًا بين الحدث وردِّ الفعل؛ كالحزن المبالغ فيه على أمور لا تستحق، وكذلك الشّعور بالظلم المُبالَغِ على أقل شيء.
شعور الاستحقاق
ويعني التفرُّد الذي يشعر به الفرد، وامتلائه بحس التميُّز والرِّيادة المتوَهم، بالإضافة إلى التوقعات العالية التي ينتظرها من أفراد المجتمع، والحفاوة به وبأفكاره. مثال لذلك؛ الغضب الذي يملأ بعض الشّباب نتيجةَ عدم حصوله على فرصة عملٍ ما، رغم ضعف مؤهلاته العلميّة، أو الرّغبة السّريعة بالثراء دون المرور بالمتاعب والتدرج في العمل التجاري، بل أصبح الأمر أشد سوءًا؛ فأصبح الشاب يحزن ويغضب لعدم انتشار حساباته على مواقع التواصل وعدم شهرته.
يُشار إليها بمتلازمة بيتر بان
وقصد به الأشخاص الذين لم يكبروا بعد؛ بمعنى أنهم شباب نشؤوا دون أن تكون لديهم رغبة في النُّضج، فهم لا يتحمَّلون المسؤوليات ولا الضُّغوطات؛ مما يجعلهم أطفالًا ولكن بأجسادٍ كبيرة. ومن مظاهرها اعتبارُ سنوات العشرينات بالنسبة للشّباب سنّ نموٍّ وليس اكتمال؛ كالاعتماد على الأهل في المعيشة اليوميّة، وأخذ المال من الأب بالنسبة للرجال، وعدم صلاحية الشاب أو الفتاة للزّواج رغم بلوغ سنه بسبب الاتكالية والاعتمادية في أقل أمور الحياة.
إهمال التّاريخ والغرق في التفاصيل
وعُنِيَ به سعي الفرد إلى أن يحقِّقَ ذاته على المستوى اليوميّ؛ كأن يهتمّ بالفنون والعمل وكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياته وتحقيق أكبر قدرٍ من المتعة، في مقابل إهمال كل أمرٍ يندرج خارج ذاته؛ كالشّأن المجتمعيّ والدّينيّ والسّياسيّ والحضاريّ. ومن المظاهر الشائعة أيضًا؛ الاهتمام بالموضة ووسائل التّرفيه، وغياب جذوة الحرارة المشاعريّة إزاء القضايا الكبرى للمجتمع والأمَّة.
تحوُّر مفهوم التَّعاطف
فيشيع عن التّعاطف فكرة أن تكون أكثر لطفًا مع صاحب المعاناة مهما كانت إساءته وخطأه، والتشوُّه الذي أصاب مفهوم التّعاطف من حيث غياب اقتران التّعاطف بالحدود؛ إذ إنّ التّعاطف الحقَّ هو الذي لا يُقرِّع الأفراد ويلومهم، بل يساعدهم على تحمُّل مسؤوليّة سلوكياتِهم وتصحيح أخطائهم. فبتنا نرى هذا التّعاطف المشوّه في عصرنا يمتدُّ لقضايا محسومةٍ في التشريع الإسلاميّ؛ كالرِّدة والرَّجم والشُّذوذ، فنشأ توجّه يستنبذُ الحدود نتيجةً لتحوِّر المفهوم.
أسباب المرض:
أورد الخبراء أسباب عدة لمرض الهشاشة النفسية، ألخصها في أمرين:
شدة الدلال، مع قلة الوجود الحقيقي للأسرة.
قد يستغرب البعض كيف الجمع، فأحدهما وثيق الصلة بالآخر؟
والحق أنهما منفصلين أشد انفصال؛ فالدلال هنا إنما هو دلال مادي بحت، يتمثل في زيادة الرفاهيات والماديات، عدم تكليف الابن بأي أمر أو تحميله مسؤولية أخطائه، ومحاولة وضعه دائمًا في دائرة حماية لا تنفك عنه في تعاملاته مع المجتمع المحيط، بينما يُترك تمامًا لعوالم افتراضية تشكل خبرته وتعاطيه مع الحياة، حيث يكون أصعب حل فيه هو ضغطة زر، بينما لو انتقد أحد الأقارب تصرف خاطئ ما في الواقع، يرفع الوالدان جدار الحماية فورًا؛ فهما لا يسمحان أن تُجرح مشاعر طفلهما المدلل، بالإضافة للطلبات المجابة والأموال المتاحة، والشاشات التي تحيط بالابن من شتى الجهات.
ومع هذا كله فلا تجد أسرة حقيقية تحيط بهذا الطفل البائس؛ فالأمر كما عبر عنه أحد الباحثين: “أب غائب وأم تحقق ذاتها”؛ فلا يجد هذا الابن من يشبعه حبًّا وحنانًا وعطفًا وتفهمًا، من يتحدث معه عن كل ما يدور بخلده ومن يجاوب عن أسئلته وينقل له خبرته.
فيخرج لنا شاب جائع نفسيًّا ومتضخم ماديًّا، حتى لا يكاد يرى أو يعبأ إلا بنفسه.
نلاحظ هنا أن منشأ هذا المرض هو الأسرة والتربية منذ سنوات العمر الأولى.
كانت واحدة من هؤلاء اللاتي كتبن حول ظاهرة الهشاشة النفسية لدى الجيل الجديد هي الكاتبة البريطانية كلير فوكس، التي نشرت مؤلفًا بعنوان “أنا أجد ذلك هجوميًا”. لاحظت فوكس أنها خلال إحدى محاضراتها في الجامعة كان الشباب يناقشونها بنفسية الضحية، تُجرح مشاعرهم من أقل شيء، ويشعرون بالإهانة من أصغر كلمة، وأحيانًا يتعمدون إظهار هذه النفسية الضعيفة من أجل جذب التعاطف. هذه الحالة الدائمة من الشعور بالضعف تحطم صلابة المرء النفسية وتجعله معرضًا للتحطيم الكامل مع أول صدمة في الحياة الحقيقية.
ولا تتوانى فوكس في إظهار سلبيات هذه النفسية المستضعفة قائلة: (والآن نحن أمام جيل من المراهقين والشباب الذين يعتبرون أنفسهم ضعفاء وهشين، ويعتقدون أن مناداتهم بألفاظ سيئة، يؤدي إلى مرضهم نفسيًّا، وأنهم لن يستطيعوا النجاة بدون علاج نفسي من طبيب متخصص. إنهم يضيفون المرض النفسي على كل شيء: مشاكل الحياة، الاستقلالية اليومية، الامتحانات الجامعية، والنقد الموجه لهم).
ضعف وهشاشة بلغت مبلغها حتى بات الشاب لا يتقبل أي نصيحة ويعتبرها حكمًا عليه، فأصبح محو فكرة الحكم بكليتها سائدة بقوة بين الشباب، البعض يريد أن يفعل ما شاء وقتما شاء، دون رادع ولا وازع، والويل كل الويل لمن يفكر أن يردّ الناس إلى الحق وإلى ميزان الشريعة.
وحتى يهربوا من عناء الحكم عليهم بواسطة الناس، لجأ كثير من الشباب الآن إلى الاندماج في المجتمعات والمساحات التي توفر لهم مناخًا لا يعترض فيه أحدٌ على أحد، ولا ينصح فيه شخصٌ شخصًا، وتغيب فيه تمامًا معاني النصح، وإنكار المنكر، وإبطال الباطل، وإحقاق الحق.
وبدلًا من أن يصبح مفهوم المساحة الآمنة Safe Space مفهومًا منضبطًا يراعي تطوير كافة من ينضمون له إلى مستوى أرقى ذهنيًّا ونفسيًّا ومهاريًّا، تخبرنا كلير فوكس أن المساحة الآمنة حاليًّا تعني الحماية من أي فكرة معادية أو سلبية في نظره؛ فحتى النقد البناء والنصيحة الصادقة غير مسموح بها في هذه المساحات.
وعليه فقد أوضح الباحثون حقيقة أن الهشاشة النفسيّة لا تعد مرضًا نفسيًّا، بل هي أسلوب تربية وليست طبيعة.
العلاج:
قبل الانتقال إلى العلاج، نسوق تعريف الصلابة النفسية في رأي الخبراء والباحثين فالشيء يتضح بضده، وهي “ما تملكه من قدرة على مقاومة وإدارة الضّغوط وشدّة المهام حولك والألم بأقل مستوى من القلق والشكوك في نفسك، وهو ما تتمتع به من تأقلمٍ عالي المستوى تجاه التّحديات حولك، وسرعةٍ في النهوض بعد الانتكاسة”.
وهذا ينقلنا إلى محاولات العلاج، وأرفقها هنا كما وصفها الباحثون المسلمون -بتصرّفٍ يسير-:
التكليف
ففي ديننا يشب الطفل على أنه مُكلف على شتى الأصعدة دينيًّا وقيميًّا واجتماعيًّا.. إلخ. وليس هذا فحسب؛ بل إنه محاسب على التقصير والتفريط والإهمال. فعلى المربي أن يدرك أن تكليف الطفل بالأمور الواجبة في سنّه والتي تناسبه هو باب إصلاح عظيم وليس كما يظن البعض أنه قسوة وعدم إدراك وما إلى ذلك من أمور مُتَوهَّم
غرس حقيقة أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله
وأننا مستَخلفون في الأرض، ولا بد أن نكون على قدر هذه الحقيقة ولا نتضعضع أو نخيب.
غرس مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ومن ثم تقبل النصح قبل إسداءه للغير وأخذه على محمل الجد.
تربية الإرادة
وهناك ثلاث طرقٍ أساسيّة في تقوية الإرادة، وهي التّذكير بقدرِ الله سبحانه وتعالى، ثمّ ترسيخ موقف الحساب يوم القيامة، ويليه مركزيّة الصّبر في حياة المسلم.
الحزم والصرامة
التربية تحتاج إلى كثير من الحزم والصرامة وبعض الخشونة في التكليفات المناسبة، وتعويد الابن على تحمل مسؤولية أخطاءه؛ وهذا يختلف تمامًا عن القسوة، وتعويده على تحمل النقد وتقبله والاستماع إلى النصح.
عدم التطلع لما عند الغير
ليس كل ما يطلبه الابن يحصل عليه، ومن المهم التعود على عدم التطلع للغير، وإلا يربط سعادته بما يملك من ماديات.
تجنب الشاشات وتقوية العلاقات الأسرية وإشباعه عاطفيًّا ووجدانيًّا
وهكذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي جمعنا فيه نتائج بحث وآراء الخبراء والعلماء والباحثين.