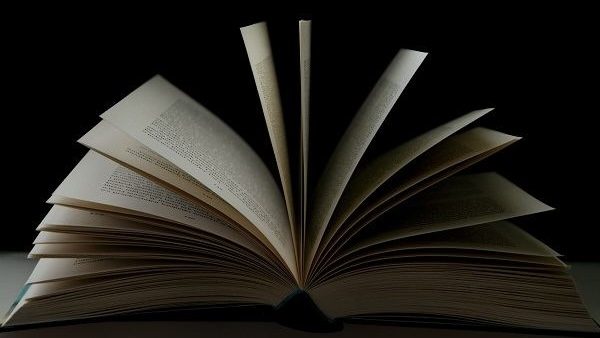كيف بك وأنت ترى طفلة بالكاد بلغت العاشرة من عمرها، وهي تهون مصاب جلل عن قريبتها التي فقدت طفلها الصغير قائلة: (اصبري واحتسبي، فالله عز وجل لا يقدر لنا إلا الخير، لعل طفلك كان شب وكبر ثم أصيب ببلاء عظيم في دينه، فلم تكن وفاته الآن إلا عافية له ولك، ألم تقرأي القرآن؟ ألا تعرفين قصة الخضر مع الغلام الصغير)، كان هذا الكلام يخرج من فم البنت بنبرة تقطر مواساة وحنواً، حتى أن تلك المرأة قد توقف دمعها من حلاوة المنطق، وأخذ لسانها يلهج للصغيرة بالدعاء، فنبرتها كانت تنم عن عاقلة تصبر نفسها وتواسيها بتلك الموعظة قبل أن تواسي بها من تحدثها، فوقع الكلام في قلب كل من سمعه.
صمت الجميع وتفكرت فيما قد يغرس في البنت كل هذا اليقين الذي أثمر سكينة وجلداً وصبراً، حتى في موقف شديد كهذا، فلم أجد غير القرآن!
ثم تفكرت كيف أخذت القرآن بهذه الطريقة التي تمكنها من الاستهداء به، وبث الطمأنة فيمن حولها بمنتهى البساطة والتلقائية؛ فلم أجد غير استصحاب القرآن في الحياة. لا أظن أن مجرد حفظ من طرف اللسان يمنح تلك السكينة والحكمة؛ وإنما العيش مع معاني القرآن حالاً ومقالاً، فلربما كانت دائمة البحث عن حاجتها فيما تحفظ من كلام ربها، ولربما رزقها الله عز وجل بأم أو أب أو معلمة غرست فيها المعنى الصحيح لحفظ القرآن واقترانه بالعمل، ومتانته بالفهم، وثباته بالتدبر، ومصحابته والاستهداء به في ظلمات الحياة التي نحياها.
لا أرى طفلاً يستحق الغبطة؛ إلا طفلاً رزقه الله عز وجل بمن ينير طريقه بكلام ربه، فيشب ذاك الصغير وقد تشبع بالنور حتى أنه يضيء الطريق لغيره، فيكون كالغيث أينما حل نفع. ولعل ذلك لا يكون إلا إن وجد من يعمق معانيه في نفسه، ويقوي الروابط بينه وبين كلام ربه؛ فيذكره في كل حركة وسكنة بآية من آيات ربه، يضرب له أمثال القرآن، يلقي عليه آيات القرآن التي تناسب أي موقف، ثم يبدأ بمنتهى الحكمة واللطف في شرحها واستخلاص العبرة منها أو الأمر أو النهي…
ولعل هذا المعنى هو المرادف لقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: (لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا وَإِنَّ أَحْدَثَنَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ فِيهَا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ يَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّقَلِ).
بركات القرآن عظيمة، وكلام القرآن عن القرآن يأسر القلوب وتتجلى منه تلك البركات والرحمات التي لا يستغني عنها أي إنسان، تدبر تلك الآيات، وغُص في معانيها؛ ستجد أن كلام تلك الطفلة كان أمراً بديهياً جداً لإنسان عاش بالقرآن؛ لكنه قد يكون أخفى على غيره، خاصة في أوقات المحن والابتلاءات.
قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: 9]، ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185].
علينا أن نتبع طريقة الصحابة رضي الله عنهم، في أخذ القرآن، وخاصة تعليمه لأبنائنا؛ كما وصفها سيدنا جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا). “حَزَاوِرَةٌ” جمع الحَزْوَر؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي وحَزُم.
ولا يفهم من الكلام أنها دعوة لترك حفظ كتاب الله عز وجل أو إهماله؛ وإنما هي دعوة لتطبيق ذلك الحفظ وترسيخه بالفهم والتدبر والعمل والاستهداء به في كل شئوننا، وغرس تلك الأمور كلها في نفوس الصغار وقلوبهم.