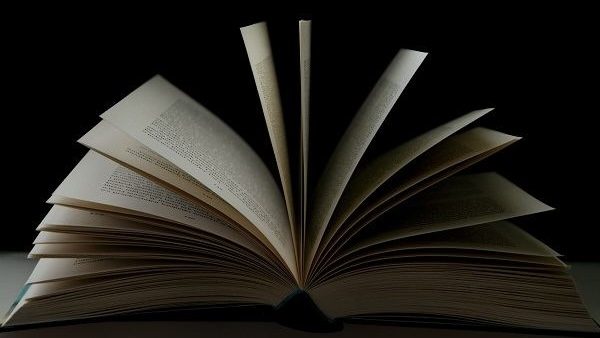يحكى أنه في جانب ناءٍ من إحدى القرى، خلا من البيوت والناس إلا من بيتين اثنين، كان البيتان يعيشان بجوار بعضهما بمنتهى الهدوء والسكينة، وكان أهل البيتين كالأهل والأخوة ولربما أقرب، يقضي أحدهما حاجة الآخر ويسانده ويعاضده ويشاركه في الألم والفرح. إن نقص عند أحدهما شيئاً؛ طلبه من الآخر، الأطفال كالأخوة؛ يطرقون أي بيت منهما فيفتح لهم ويُرحب بهم. لم يخل أي فرد من أفراد الأسرتين من عيوب ولم تخل الحياة من بعض المشاكل؛ لكنها كانت سرعان ما تحل بمنتهى الود والتفهم والتغافر، وسرعان ما يعود الهدوء والسكينة والألفة لتظليل سماءهما، وتعود الحياة لطبيعتها الودود المعهودة.
مرت الأيام هادئة، والوضع كما هو، ثم أتت عائلة جديدة وابتنت بيتاً بجوارهما وانتقلت للعيش به. رحب الجاران بالجار الجديد، ومضت الأيام رتيبة؛ لكن أحد الجارين قد توطدت علاقته شيئاً فشيئاً مع الجار الجديد، ومع هذا الاندماج، بدأت المشاكل بين الجارين الأصليين تأخذ شكلاً مختلفاً، فأصبحت المشاكل تأخذ حيزاً أكبر مما كانت تأخذه قبل، وأصبح الشيء الصغير يوقف عليه ولعله تحول إلى شيء كبير، حتى تعامل الأطفال فيما بينهم قد اختلف؛ لكن العلاقة لم تنقطع وظل جزءاً من الود قائماً.
مرت الأيام ووصل جار جديد، ويبدو أن ذاك الطرف النائي سيتحول إلى حي مكتظ بالسكان. تعرف الجيران على بعضهم البعض؛ لكن الجار الثاني من الجارين الأصليين قد اندمج سريعاً مع الجار الجديد، وهنا تحولت تلك المشاكل البسيطة بين الجارين القدامى إلى صراعات، وتلك العيوب التي كان يعذرها أحدهما للآخر ويغفرها أصبحت كابوساً لا يطاق بالنسبة لكليهما. زادت المشاكل بينهما حتى وصل الأمر إلى قطيعة، طالت حتى الأطفال الصغار الذين أصبح كل واحد منهم يتفنن في إيذاء الآخرين، وأصبح كل جار يتمادى في إيذاء جاره كأن لم تكن بينهما مودة يوماً.
تأملت تلك القصة طويلاً، وأنا أحاول أن أجد تفسيراً لهذا التحول المخيف في علاقة هذين الجارين. لم أستطع أن أجد تفسيراً، حتى قفز بذهني قول الله عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾.
استوقفتني هذه الآيات طويلاً، وقد رأيت فيها من بشاعة بني آدم ما لم أكن أراه من قبل، فهذا هو الإنسان الذي لا يستغني عن ربه عز وجل طرفة عين؛ يطغى ويتجاوز حده مع ربه سبحانه وتعالى حين يظن أنه أصبح غنياً عن ربه، سواء بمال أو جاه أو ولد، وهو الجاهل المسكين مركوس العقل مطموس الفطرة منكوس القلب، لو تفكر قليلاً؛ لعلم أنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لكنه الطغيان.
فكيف بهذا العبد حين يظن أنه يستغني عن إنسان مثله، والاستغناء في ذاته ليس عيباً ولا مذمة؛ بل هو مكرمة إن تجمل بالتقوى والإيمان والأخلاق، وإن كان قربة لله عز وجل؛ لكنه يكون بشعاً حين يصاحبه الطغيان وقلة المروءة وانعدام الشرف، فيفجر الإنسان في خصومته ويطغى في أذاه وظلمه.
ولطالما تكررت تلك القصة بصور شتي بين الجيران والأهل والأصحاب والأزواج. والحل هو أن يتقي كل إنسان ربه عز وجل، ويبتغ بكل فعل يفعله وجه الله عز وجل، ويعلم أن باب المعاملات من أعظم أبواب الجنة إن راقب الله عز وجل فيه، ويدرك حقيقة الدنيا؛ فما هي إلا لحظات نقطعها في هذه الدار ثم ننقلب إلى دار الخلود، فيحاسبنا الله عز وجل عن الكلمة والهمة والنظرة والإشارة. الدنيا بأسرها لا تساوي شرارة من النار قد تصيبنا، فنستعيذ بالله عز وجل من النار، ونستعيذ به من الطغيان؛ ألا نطغى ولا يُطغى علينا.