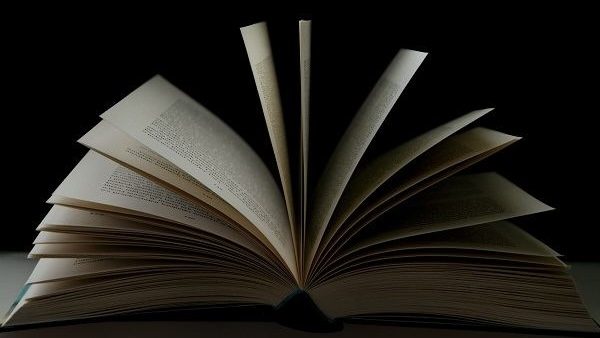إن الإسلام دينٌ أفرغت فيه كل معاني الرفق والرحمة والحكمة، ودينُ الغرب فُرِّغت منه كل معاني العدل والرحمة؛ فكانت إنسانيتهم لفظاً يتشدّقون به بلا معنى، قِشرة بلا لب.
غُراباً ينعق مُصدعاً الرؤوس، ظاناً أنه يخدع من حوله من الطيور وأولي الألباب بريشه الملوّن المصبوغ؛ لكن هيهات أن يطول بهرجه، فأمطار اليقين من غمام قلوب العباد المؤمنين ما تلبث أن تكشف زيف تلك الأصباغ.
إن أمتنا لَأجلُّ أمة، عطفت على الضعيف الذي لا يُؤبه له ولا يُرجى منه نفعاً؛ فكان نبيّها صلى الله عليه وسلم يردد: “إنّما تُنصَرون بضعفائكم”، وأُمة الغرب يُداس الضعيف عندهم بالأقدام.
وإنها أرقى أمة، عظّمت من قيمة المرأة. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “أمك ثم أمك ثم أمك”، وكأن أجنحة سماوية تورق من تلك الكلمات فتعلو بالمرأة من الدَرك التي وضعها فيه قوم ذوي جاهلية نتنة إلى رحابة الإسلام.
أما في الغرب اللامسلم؛ تُرمى الأم في مأوى العجزة أو تُركن في بيت ناءٍ بلا سؤال الأولاد ولا ضجيج الأحفاد المحبّب، وتُصلب المرأة الغربية على جدار التهميش والإذلال؛ فتُراها تتخبّط يُمنة وشمالاً بعد أن وصلت سن البلوغ، باحثة عن أخدان؛ لأن والديها غير مسؤولين عنها. وتَراها تُنهك من وظائف ما راعت طبيعتها الجسدية والنفسيّة، في حين تُكرَم المرأة المسلمة بقوامة الرجل عليها.
وإنها الأمة الوحيدة التي ساوَت بين أفرادها؛ فالمعيار الحقيقي هو التقوى. فلا الأحمر يتقدّم على الأسود ولا الأبيض بأفضل من الأسمر، قلبك هو ميزانك، لا تلك القشرة الرقيقة التي تكسو عظامك وأعصابك. ففي موقف جليل عظيم يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: (أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا. يعني: بلالًا). نعم، هذا بلال العبد الأسود الذي لم يكُ حتى يحلم بالسيادة؛ لكنه الإسلام، دين يعزّ أفراده ويسمو بهم فوق ترابيتهم!
ويأتي رسولنا صلوات ربي عليه مبشراً بلال رضي الله عنه: “سمعت دفّ نعليك في الجنة”؛ فالجَنة ليست حكراً على ذوي المناصِب أو ذوي الأموال كما كان في إحدى حقبات النصارى التي بلغ التحريف مبلغاً عظيماً فيها؛ فكان “الباباوات” يبيعون صكوك الغفران!
وإنها أمة وضعت حدوداً صارمة على بعد مسافة شاسعة من المنحدرات؛ فتحرم الاختلاط، وتفرض على النساء الاحتشام وغض البصر، وعلى الرجال غض البصر وتقوى الله. بينما يسنُّ الغرب “الأضحوكة” كل سنة قوانين لحماية الساقطين من الجُرف، مع ارتفاع في إحصائيات الإجهاض والاعتداءات.
إنها الأمة التي يزكو فيها قلب المؤمن حتى يرقّ ويلين؛ فيشجيه مرأى الأطفال، فيقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه من قلب زيد هذا الطفل الذي يلاعب عصفوره الصغير، فيناديه بكُنيةٍ تعظم من شأنه وتزرع الرجولة في خلاياه، ويربت على روحه الغضّه بسؤاله: “يا أبا عُمير ما فعل النُغير”. ويقود أسامة بن زيد، الرجل الفذّ، جيشاً عرمرماً وهو أصغرهم؛ لكنه صاحب بوصلة ووجهة واضحة ورجولة مكتملة؛ فلا تعرف التفاهة إليه سبيلاً.
فالأطفال جزء من هذه الأمة، اللبنة الطرية التي ستغدو الجزء المتين في أساسها؛ بينما يمنح الغرب للطفل الحرية بلا أي حواجز أو حدود؛ فيعيش في صراع مع نفسه التي بين جنبيه وهويّته الجديدة التي انتحلها والقديمة التي فارقها. فلا الرجولة رجولة بحق ولا الأنوثة أنوثة!
ويغرق أطفال آخرون في وحل المخدّرات؛ لأنه حُرّ، ثم يطرق أبواب العيادات النفسية منتهياً للانتحار. وتمتلئ دور الأطفال والشوارع من الأطفال مجهولي النّسب الذين لم تحفظ لهم أمّتهم حقوقهم حتى في الانتساب لأب وأم والعيش بكرامة.
يفهم الواحد منا من “تكرار القسم” أهمية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذي لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ”؛ بينما أقل شيء ممكن يجعل جفناً في الغرب لا يُغمض، صراخ الجار المعتوه الذي أسرف في المسكرات، ولا تستطيع أن تتفوّه بحرف؛ لأنها “حريته الشخصية”.
إن ديننا الحنيف موسوعة من القيم والأخلاق، فلسنا بحاجة لاستيراد القيم الكاذبة والقوانين الباهتة. وتاريخنا ضارب جذوره في أرض الله عز وجل ،فشارعه الله الحكيم الخبير، الأعلم بمن خلق ونفوسهم، وأخلاقهم وأمراض قلوبهم؛ فلا تنظروا بعين الدهشة لمن انحرف عن صراطه، ولا تدعوهم يمارسون الأستذة عليكم، ولا تخدعنّكم إفرازات العقول البشرية أبناء الطين، ولا تخدعنكم بغتة أمة بنيت من جماجم الضعفاء بتمثيليّة الإنسانية التي يفوح منها رائحة الكذب والدم وتتناثر حولها أشلاء اللحم الذي كانت حنجرة الغرب الكاذبة تصدح بحقوقهم البارحة!
شهد فادي
إن السائر على الصراط المستقيم يحوي السماء في صدره؛ فما يفتأ يسمو ويرقى بقلبه ونفسه، والضال عن الصراط يراكم وحلاً فوق ترابيته؛ فما يلبث يدنو إلى أن يسقط.