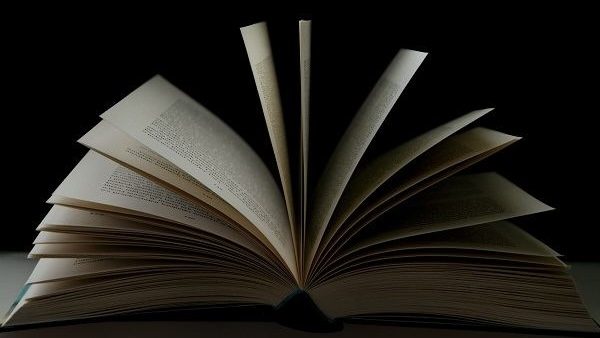هذه الشبهة من الشُبه التي قد تبدو سخيفة ممن يطرحها، فعلاوة على ما ثبت طبياً وصحياً وبالتجربة من أثر الصيام في نشاط البدن وصحته سُفهت بها هذه الشبهة، إلا أنها في الحقيقة شبهة تحتاج للنظر في جذورها، فهي شبهة متمخضة عما هو أعمق منها وأخطر! وهو “التعليل المادي” لأوامر الشريعة والانطلاق من التمركز حول الإنسان ومنفعته والنظر للأوامر الشريعة على أساس ذلك قبولاً أو إعراضاً.
وهذه الشبهة وما دار في فلكها هي من نتاج المدنية وتعظيمها واللهث وراءها، والجري خلف الحياة الدنيا وجعلها من المركزيات في حياة الإنسان، ومحاولة ربط الشعائر والعبادات بأي نفع مادي دنيوي متعلق بالإنسان وصحته وسعادته بشكل محض، وإغفال ما تقوم عليه هذه العبادات من أصول عظيمة تتوج بالعبودية لله وطاعة أوامره بذلك، في محاولة منهم لاختزال مقاصد الشريعة الأولية والإعراض عنها وتحويلها لمقاصد مادية إنسانوية توظف في مقاصدهم وحسب.
فالعبادات لديهم بهذا المنطلق: وسائل لغاية معينة (منفعة الإنسان) إن تحققت تمت العبادة وكمُلت. بينما في الحقيقة أن العبادات والشرائع هي غايات في ذاتها ومقاصد مرغوبة يحبها الله جل جلاله، فهي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وأوجدهم من العدم كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، كما أن هذه العبادات من صيام وغيره هي من الحق الخالص لله وحده دون غيره لكماله سبحانه، وقد دلت على معنى حُب الله للعبادة ومحبته لأن يقوم الناس بعبادة الله الآيات والأحاديث الكثيرة، كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، وكذلك قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ}، فمن فعل ما يحب الله امتثالاً وطاعة قربه الله إليه وأحبه؛ فالعبادة من الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده.
كما أن القيام بالعبادات ليس مؤثراً على الجسد فقط، فالقيام بها يملأ القلب إيماناً ويرتقي بالعبد في مدارج العبودية وتُطهر العبادات قلبه من الدنس وتزكيه، وهذا الجانب الإيماني لا يعقله أصحاب التفسيرات المادية للشرائع، وقد بيّن الحق -سبحانه وتعالى- أن إحدى مقاصد الصيام هي التقوى كما قال عز من قائل: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ}. فسمو النفس إيمانياً مقصد من مقاصد العبادات وغاياتها، وهو الباعث للنفوس على كل خير والمقرب لها من الملك سبحانه، وإذا تزكت النفوس صلحت دنياها واخرتها.
والأمر بالصيام كغيره من العبادات مما قد يشق على النفس، وهذه المشقة لا تنفك عن العبادات وبها تظهر مُخالفة الهوى وتمحيص الله للعباد بهذا الابتلاء، أيمتثلون للأمر الإلهي أم يعرضون عنه؟ وقد أشار الحق لهذا كما قال سبحانه: {لِكُلࣲّ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةࣰ وَمِنۡهَاجࣰاۚ وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةࣰ وَ ٰحِدَةࣰ وَلَـٰكِن لِّیَبۡلُوَكُمۡ فِی مَاۤ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ ٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعࣰا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ}.
والصيام به تغفر الذنوب وترفع الدرجات عند الله، فقد قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: “مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه”، فلا غاية أعظم للمسلم من غفران ذنبه وقبوله عند الله، وإن أصاب الجسد ما أصابه في سبيل الله.
وبهذا؛ فإن العبادات على اختلافها إنما شُرعت تعبداً لله وطاعة له وفعلاً لما يحب الله ويرضى وامتثالاً من عباده الفقراء لربهم الغني الحميد، على أنها مع ذلك فيها من الآثار السلوكية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها من الآثار التي تدخل من ضمن هذه المقاصد العظيمة فضلاً من الله ونعمة، وليست هي المقاصد الأساسية لتشريعها، وإلا لو كانت مقاصداً أولية لما كان للأمر الإلهي بهذه العبادات أي معنى -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-، فكم ممن لا يدينون بدين الله لديهم بعض تلك السلوكيات بفطرهم التي فطرهم الله عليها!
وبهذا الصدد يقول ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: (وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله، من مصالح القلوب ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة، كما قال الله تعالى: ” وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ” [الكهف: 28] وقال تعالى: ” فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ” [النجم: 30]).
فتجد كثيرًا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق، بمبلغهم من العلم، وقوم من الخائضين في (أصول الفقه) وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة، إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية، ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله، وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله، وخشيته وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته ودعائه، وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه: حفظًا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح).
وبهذا فإن الصيام بحد ذاته سبباً من أسباب تقوية بدن المسلم وروحه، وهو الذي يرتقي به لأفضل مستويات الإنتاجية في دينه ودنياه، فهو عامل للارتقاء بالنفس والجسد لا العكس كما يدعون، فالحمد لله على شرائعه الحكيمة والعبادات العظيمة التي أمرنا بها.