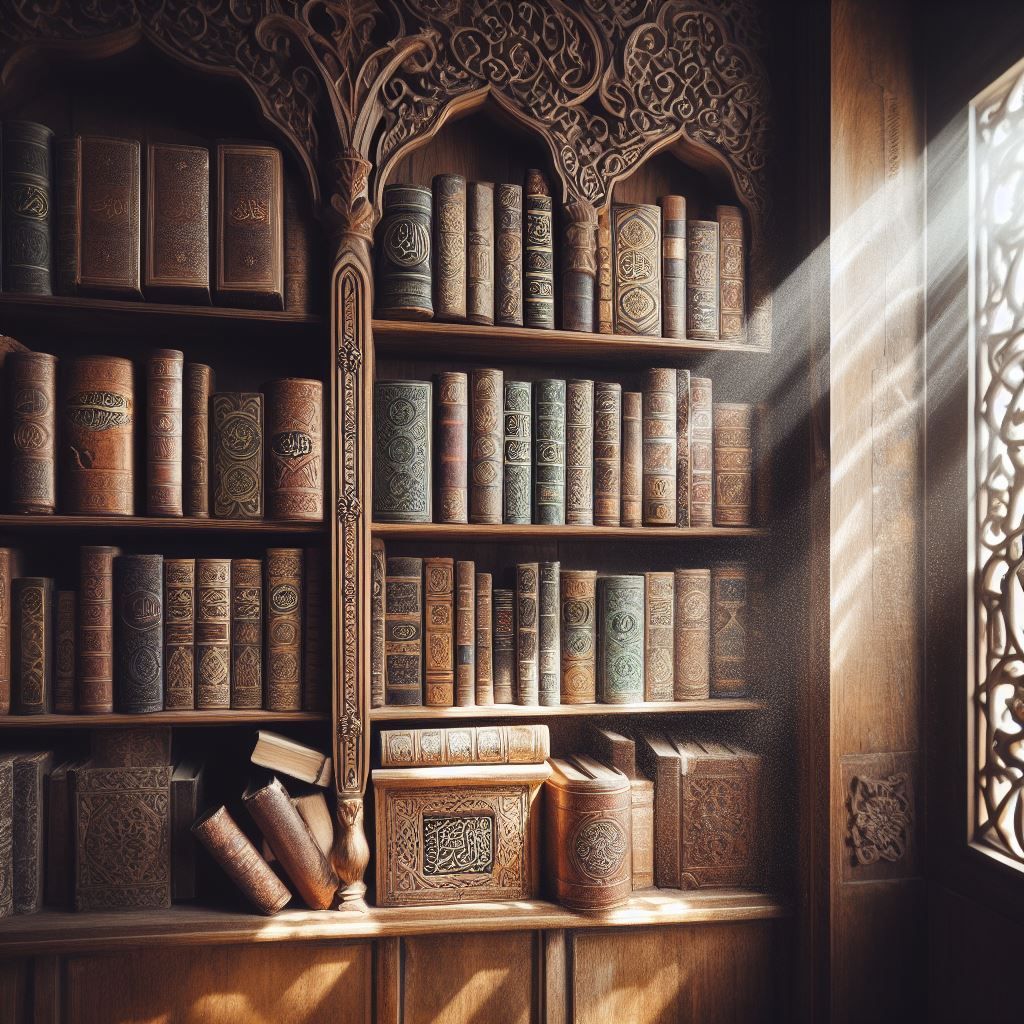ظننتُ أنّنا – نحن الأجيال التي وُلدت وسط الحروب، وعاشت القهر والرعب، ولم تعرف لاستقرار الوطن سبيلًا –
سنغدو أحنَّ وأرأف وأرحم، لكنني كنتُ مخطئة؛ فالأجيال التي تربّت في ظلّ قسوة واضطراب، قد تصلّبت قلوبها حتى صارت كالصخر الأصمّ، على الرغم من أنّ أبواب العلم مفتوحة أمامها على مصراعيها، ومجانية، ومتاحة بين الأيدي.
لطالما تساءلتُ: كيف يجرؤ الجلّاد في السجن على تعذيب ضحاياه؟
حتى رأيتُ آباءً وأمّهاتٍ يضربون أبناءهم.
وأنا لا أتحدث عن صفعةٍ خفيفةٍ على الكفّ، أو قرصةٍ على الأذن، بل عن ضربٍ يترك كدماتٍ زرقاء وحمراء، وعن طفلٍ يشحب وجهه خوفًا حين يمسك أحد الوالدين العصا، وعن ركلٍ وطرحٍ على الأرض ولكمٍ مبرّح!
ولستُ أتحدث عن آباءٍ يكرهون أبناءهم، أبدًا بل تراهم يهرعون باكين إلى المستشفى إذا ارتفعت حرارة الطفل قليلًا، لكنهم يفعلون فعلتهم باسم “التربية” و”ضبط السلوك”، مرددين العبارة المألوفة: “كلّنا ضُربنا ونحن بخير!”
ومن هنا، ما عادت قسوة السجّان تدهشني؛ فإن كانت يدُ أمٍّ محبّةٍ، أو أبٍ عطوفٍ، تقوى على الإيلام باسم التربية،
فلا عجب أن يسلخ السجّان جلد ضحاياه باسم “حفظ الأمن” و”الانضباط”.
تشير الدراسات النفسية الحديثة إلى أنّ ضرب الطفل – حتى الضرب الخفيف الذي لا يؤلم الجسد –
يترك ندبةً على الروح، فكيف بما هو أشدّ إيلامًا؟
لكن المعضلة أنّ مفهوم “التربية الإيجابية” وصلنا بصورة مشوّهة؛
فظنّ كثيرون أنّها تعني ترك الطفل يفعل ما يشاء، وتنشئة طفلٍ وقحٍ لا يعرف الحدود.
والحقيقة أنّها أرقى من ذلك بكثير:
إنها تقوم على العقاب دون أذيّة، والتأديب دون امتهان.
فبدل أن تضرب الطفل لأنه رفض جمع ألعابه،
عاقبه بألا يُسمح له باللعب مجددًا حتى يلتزم،
فيكون العقاب من جنس العمل، والتقويم دون إذلال.
لكن يبدو أن الحروب لا تُدمّر المدن فقط،
بل تُدمّر مفهوم الطمأنينة في داخل الإنسان.
وحين يفقد المرء الطمأنينة، يفقد الصبر.
وحين يفقد الصبر، يصبح الصراخ والضرب وسيلته الوحيدة للشعور بالسيطرة، في عالمٍ ينهار من حوله.
ولم نكتفِ بهذا، بل استورد بعضُ الناس – بدافع الانبهار بالغرب – أساليبه في “التأديب الجسدي”، كالضرب على الأرداف (spanking)، ظانّين أنه مظهر من مظاهر الحداثة أو التربية “العلمية”،
غير مدركين أن كثيرًا مما يُروّج في الإعلام الغربي ليس علمًا ولا تربية، بل (دراما) بلا أخلاق.
وخطورة هذا النوع من العقاب لا تكمن في الألم الجسدي وحده، بل في رمزيّته الجنسية والإذلال النفسي الذي يحمله.
فالأرداف منطقةٌ حميميّة، ترتبط لاحقًا في وعي الطفل بالخجل واللمس،
وحين تُستخدم موضعًا للعقاب،
يتشرّب عقله الباطن فكرةً خطيرة:
أنّ اللمس في هذه المنطقة “مقبول” إن أتى من الكبار أو بدافع التأديب.
وهنا يبدأ الخطر الحقيقي، إذ تضعف الحدود الجسدية في ذهن الطفل،
ويصعب عليه لاحقًا التمييز بين اللمس المؤذي واللمس المسموح، فيُربك مفهوم الخصوصية لديه، وفي بعض الحالات، يضعف دفاعاته الفطرية ضدّ التحرّش.
أما التأديب الصحيح، فهو الذي يكون نفسيًا وتربويًا بالدرجة الأولى.
وأعلم أنّ الأطفال قد يفقدون المرء صوابه، وأنّ الضرب قد يأتي ردة فعلٍ تلقائيةٍ عند نفاد الصبر.
لكنّ الضرب في تلك اللحظة لا يكون تربية، بل تفريغًا للغضب المكبوت.
فالعقاب الجسدي – إن لزم الأمر – يجب أن يكون رمزيًا، دون مساسٍ بالعورة، أو إهانةٍ، أو ترك أثرٍ، ولا يكون أبدًا في ساعة الغضب.
فمن تُرك حتى يهدأ، لن يضرب أصلًا.
والإسلام لم يُشجّع على الضرب قط،
بل جعله خيارًا أخيرًا، نظريًا، محاطًا بشروطٍ تكاد تجعل تطبيقه مستحيلًا.
لم يأمر به، بل قيده حتى يتلاشى أثره،
ليكون هدفه الإصلاح لا الإيذاء، والتقويم لا الإهانة، والتربية لا الانتقام.