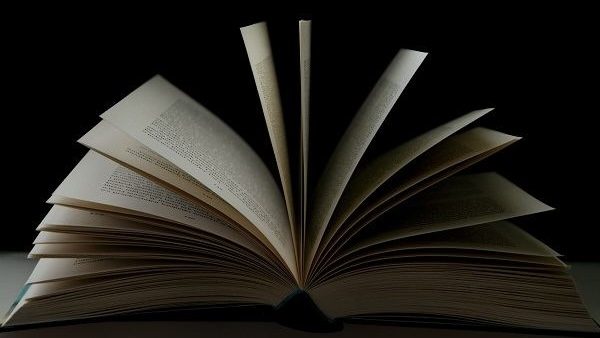أرجع بذاكرتي أكثر من ثلاث عقود إلى الوراء؛ لأعيش حدثًا بسيطًا بساطة الحياة في قريتي الصغيرة المتناثرة بين الجبال.
كنت طفلة صغيرة لا تعرف من العيش إلا اللّهو واللّعب خارج أوقات الدراسة، أو أوقات حفظ القرآن في المسجد القريب. أذكر أنّ أختي التي تكبرني كانت شديدة الحب للقراءة؛ فلا تترك جريدة ولا كتابًا وقع بين يديها إلا قرأته، رغم أنّها لم تكمل دراستها الابتدائية. والدتي كانت تشجعها على القراءة؛ حتى لا تنسى ما تعلمته في أربع سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، وحتى لا يتناثر ذلك مع رياح الزمن عبر الأيام والسّنين.
لم تكن أختي تكتفي بالقراءة، ولكنها إذا وجدت فائدة حدّثت بها ونصحت؛ فهي أكثر من كان يحدثنا عن الصلاة والذكر، وهي القارئة النّهمة والعصاميّة التي بَنَت لنفسها صرحًا نهتدي به، وإن كان الصّرح بسيطًا فقد أثَّرَ وأصاب وهدى إلى طريق الصّواب.
أذكر تلك القصة الجميلة التي روتها لي أختي، ولم أكن أدري أنّها تحوي في طيّاتها برمجة لعقلي وقلبي ووجداني، وأنّها ستضبط بوصلتي نحو وجهة واحدة تستمر معي إلى يومنا هذا، ولعلها سترافقني إلى القبر، وإنّي لأرجو ذلك.
نَظَرَتْ إليَّ أختي وقالت: سأحدِّثك عن العابدة الزاهدة رابعة العدوية. ثم أخذت في سرد القصة وتفاصيلها، وتنقَّلَت بين عباداتها وذكرها وزهدها ومناجاتها لربها وكراماتها. وكلما صالت أختي وجالت في حديثها؛ كان قلبي يهتز بشدة لهذه المعاني التي أبهرتني، حتى أدركت أنّ أعظم قصة حبّ في الوجود هي ما يكون بين العبد وربه، وأنّ كلّ حُبٍّ دون حبّ الله فهو باطل.
ورسخت في ذاكرتي أبيات شعر لرابعة، لتكون نبراسًا لي في الحياة، وطريقًا أسير على أثره. ومهما زغت عن الطريق أو ابتعدت عنه؛ فإنني أحنّ إليه كما يحنّ الوليد إلى أمه، وأرجع إلى حضنه من جديد.
وهذه أبيات رابعة:
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
إذا صحّ منك الودّ فالكلّ هيّن
وكلّ الذي فوق التّراب تراب
لقد أحسست بعد سماعي لقصة رابعة أنّ شيئًا ما تغير في داخلي، ليعلن بداية ميلاد شخص جديد، صار هدفه وطموحه مبنيا على بند واحد: كيف يجعل ما بينه وبين ربه عامرًا بالحب مثلما فعلت رابعة؟
هذا الطموح دفعني بعدها للبحث عن كل سبب مقرِّب لله موجب لمحبته، بل وللارتقاء إلى مقام المحبوبية. وكان لي من العمر يومئذ عشر سنوات، وها أنا ذا في العقد الرابع ورابعة لم تمت أبدًا، لا زالت حية في داخلي.
إنني عندما أتأمل هذا الفصل من حياتي وأثر هذا الحدث فيها؛ أدرك أن التربية الصحيحة وغرس القيم في نفوس الأبناء ليست بتلك الصعوبة التي يتحدثون عنها اليوم، وأفهم لماذا استطاعت الأُسَرُ أيام الزمن الجميل كما يقال؛ صناعة أبناء أكثر وعيًا وأدبًا واحترامًا للقيم رغم قلة الامكانيات، من أُسَرِ اليوم التي توفر كل شيء ولكنها عاجزة عن ضبط هذه القيم والمبادئ لدى أبنائها.
إن التربية مثل حرث الأرض وزراعتها تمامًا؛ فالأرض حتى تنبت زرعها تحتاج إلى عاملين مهمين: أما الأول فهو جودة ما يزرع، وإن مبادئ هذا الدين الحنيف وقيمه بذورٌ لا يُعْلَى على جَودتِها من قديم أو حديث. وأما الثاني فهو الأرض الطيبة التي تكون محلًّا للزراعة؛ فمن طابت أرضه طاب زرعه، ومن خبثت أرضه فأنّى للزرع أن ينبت؟
ولعل هذا ما أفسدته علينا مظاهر المدنية الحديثة، حيث جعلت عوامل الإفساد متاحة بالقدر الذي تتاح فيه عوامل الإصلاح. وعندما أسأنا استخدامها وجعلناها بين أبنائنا دون رقابة، وَرَّثَ ذلك خدشًا للفطرة السليمة وإفسادًا للأرض الطيبة؛ حتى صارت لا تنبت زرعها بقدر الفساد الذي حلّ بها.
يقول الله تعالى
﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾.
العبرة من كلّ هذا، أنّ علينا نحن الآباء والأمّهات أن نمنع عن الأرض ما يفسدها، وندفع من مظاهر المدنية الحديثة ما يخدش فطرة أبنائنا، حتى إذا زرعنا فيها مبدأً وقيمةً؛ ظهر ذلك في حياتهم واستمرّ معهم إلى ما شاء الله أن يستمرّ. فحتى وإن كانت الوسيلة التربوية بسيطة: قصة أو حوارا عابرا أو موقفًا؛ فبساطة الأسلوب لا تقلل من قدر المبدأ وتأثيره إذا وُجِدت الفطرة السليمة والأرض الطيبة، بل إن البساطة في كثير من الأحيان أشدّ تأثيرا وأنفذ في القلوب؛ لارتباطها الوثيق بالصّدق وعدم التكلف.
ورسخت في ذاكرتي أبيات شعر لرابعة، لتكون نبراسًا لي في الحياة، وطريقًا أسير على أثره. ومهما زغت عن الطريق أو ابتعدت عنه؛ فإنني أحنّ إليه كما يحنّ الوليد إلى أمه، وأرجع إلى حضنه من جديد.