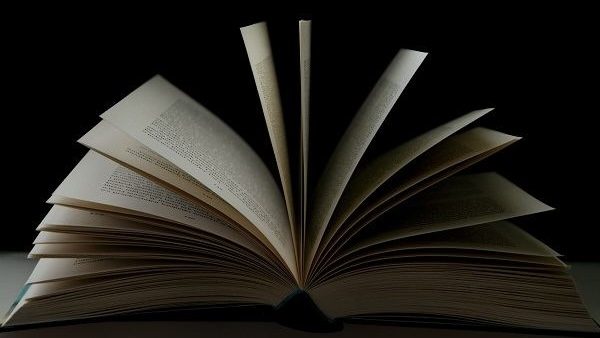مضت ساعات طويلة والمريض لم يخرج بعد من غرفة العمليات. كانت العمليّة الجراحية صعبة جداً، وتتطلب الكثير من التركيز والجهد من الفريق الطبي الذي لم يدخر جهداً في ذلك.
بعد ثمان ساعات تقريباً؛ تم إخراج المريض ووضعه في غرفة منفصلة. لقد كان في غيبوبة تامة ولا شيء يدل على حياته إلا تلك الأجهزة الموصولة بجسده، والتي تعطينا إشارات وبيانات عن حالته الصحية.
أذكر جيداً ذلك المريض، وقد كنت وقتها ممرضة في قسم الجراحة العامة. أذكر نظراته التي لم تكن غريبة عنّي عندما عمدت في كل مرة على إعطائه دواءه، قبل دخول غرفة العمليات؛ فآخر نظرات لصديقتي التي تُوفيت عند نفاسها تشبهها تماماً، وكأنها نظرات مودِّع لهذه الحياة، وكل ما يدب فيها.
تلك الليلة حُفرت في ذاكرتي؛ لهيبة الحدث الذي شاهدته أول مرة في حياتي عن قرب، بعدما كنت أقرأ عنه فيما مضى، وأستمع إلى مواعظ تتحدث عنه. وشتان بين ما نقرأ ونسمع عنه، وبين ما نراه ونشهد حدوثه. وشتان بين الإيمان واليقين.
كان الطبيب يومها يتردّد على المريض مراقباً لنبض قلبه، وتنفسه، وضغطه. وكنت مرافقة له في كل مرة يدخل فيها عليه، رغم أن ذلك لم يكن ضمن قائمة واجباتي في مداومتي الليلية؛ إلا أنني أحسست أن شيئاً ما سيحدث وعلي أن أشهد هذا الحدث.
لاحظ الطبيب يومها حرصي واهتمامي، وكأنه أحس بما يدور في داخلي، وقد كان إنسانياً متفانياً في عمله إلى درجة كبيرة؛ وهذا ما جعله يفسح لي المجال لمراقبة الوضع الصحي للمريض طيلة تلك الليلة، وإخباره بأي طارئ قد يحدث.
أذكر أنني جلست في زاوية الغرفة وعيني على هذا الرجل الممدد، الذي يصارع ما ألمّ به في صمت، راضياً بما قسمه الله له، ومستسلماً لقضائه. وفجأة رأيت شيئاً ما يتحرك من جسده، ولا شيء يتحرك غيره.
لقد كانت سبابته اليمنى، وكأنه علم بانقضاء أجله قبل سويعات، فتجهز لخروج الروح بذلك؛ حتى يكون راضياً مرضياً. ومن كان آخر كلامه “لا إله إلا الله” دخل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وما زال على ذلك الحال رافعاً سبابته، حتى حانت لحظة الصفر التي توقف عندها كل شيء. لقد كانت لحظة مهيبة ومقاماً تملأه الرهبة عندما وقفت أعاين المريض، ويقيني أنه فارق الحياة متشهداً رافعاً سبابته.
لم أكن وحدي بالغرفة؛ فقد استشعرت هيبة المكان في وجود ملك الموت ومن معه من الملائكة، ولم أَرَ نفسي إلا أخرج سريعاً، وقد انتابني الخوف معلنة وفاة المريض.
أذكر أنني انزويت في مكان بعيد خارج الغرفة، حيث دخل فريق خاص إلى المتوفى، فجردوه من كل شيء، ثم أخذوه إلى غرفة حفظ الجثث ليتم تغسيله فيما بعد.
كانت هذه اللحظات مهيبة جداً، لم يغب فيها استحضاري للحقيقة التي تنتظر كل إنسان على هذه المعمورة. فمثلما حدث مع هذا الرجل سيحدث معنا غداً؛ فطوبى لمن عمل صالحاً يدخره لمثل هذا المقام.
ما زلت أذكر بكاء أخيه بحرقة، وكان أكثر عائلته حزناً وألماً بهذا الفراق الصعب. لقد كان يتحدث عنه والألم يعتصر قلبه والدموع تخنقه: مات نور عيوني، مات أخي، مات سندي.
لم يتوقف الأخ عن ذكر مناقب أخيه وطيبته، وأنه لم يكن أخاً عاديّاً أبداً، فبرحيله رحل كل شيء، ولم تَبقَ إلا رحمة الله عوضاً وأُنساً لقلبه المنكسر.
ما أقسى هذا المشهد، وإنه المشهد الأخير في حياة كل واحد منا. ستفارقنا الأرواح ونُجرد من الثياب، ونُغسّل ونُكفّن ثم نُدفن. سيبكي علينا من بكى برهة من الزمان، ثم تعود المياه إلى مجاريها، والحياة إلى طبيعتها، وينشغل كل واحد بما أهمّه.
لن ينفعنا في ذلك المكان المظلم الضيق في بطن الأرض إلا ما ادّخرناه في هذه الحياة من صالح أعمالنا.
فهلَّا أعددنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم؟
النّفس تبكي على الدّنيا وقد علمـــــــــــــت
أن السّعادة فيها ترك ما فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لا دار للمرء بعد الموت يسكنــــــــــــــــــــــــــــــها
إلّا التي كان قبل الموت بانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وإن بناها بشرٍّ خاب بانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
أموالنا لذوي الميراث نجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــها
ودورنا لخراب الدّهر نبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
أين الملوك التي كانت مسلطنـــــــــــــــــــــةً
حتّى سقاها بكأس الموت ساقيـــــــــــها
فكم مدائن في الآفاق قد بُنيــــــــــــــــــــــــت
أمست خراباً وأفنى الموت أهليـــــــــــها
لا تركننّ إلى الدّنيا وما فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
فالموت لا شكّ يفنينا ويفنيــــــــــــــــــــــــــــها
كانت هذه اللحظات مهيبة جداً، لم يغب فيها استحضاري للحقيقة التي تنتظر كل إنسان على هذه المعمورة. فمثلما حدث مع هذا الرجل سيحدث معنا غداً؛ فطوبى لمن عمل صالحاً يدخره لمثل هذا المقام.